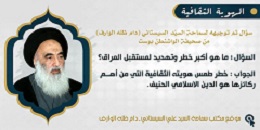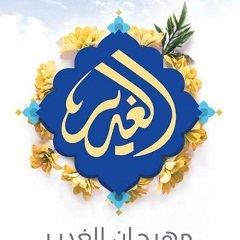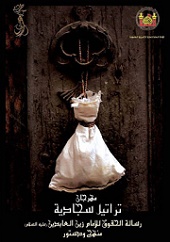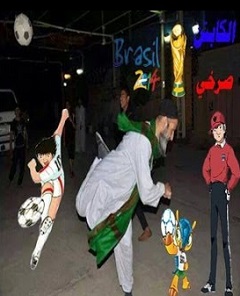أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) : قراءة فلسفية في الذاكرة والهوية والمعنى
جاسم محمدعلي المعموري
 المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
جاسم محمدعلي المعموري
تُعد أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام ) ظاهرة دينية وإنسانية فريدة في التاريخ الإسلامي، حيث تجتمع في هذه المناسبة أبعادٌ متعددة: الروحي، الاجتماعي, السياسي,
والميتافيزيقي. فهي ليست مجرد إحياء لذكرى مرور أربعين يومًا على استشهاد الإمام الحسين في كربلاء عام 61 هـ، بل تحوّلت إلى طقس إنساني عالمي يجمع ملايين البشر على قيم محددة كالعدالة, والتضحية، والحرية، ومقاومة الظلم.
وهي الحدث الثقافي الأبرز في العالم الإسلامي، لا سيما في السياق الاسلامي الشيعي الإمامي. يتوافد الملايين إلى كربلاء في ذكرى مرور أربعين يومًا على استشهاد الإمام الحسين في واقعة الطف , لإحياء ذكرى شكلت عبر القرون محورًا لهوية دينية، ومشروعًا أخلاقيًا – سياسيًا يتجاوز الإطار الطائفي ليطرح أسئلة كونية عن الظلم، الشهادة، والمقاومة .
ترى ما الذي يجعل من أربعينية الحسين (عليه السلام ) حدثًا متكررًا في الزمان لكنه خالدٌ في المعنى؟ كيف تتجلى مفاهيم الهوية، الذاكرة, والزمان في هذه الشعيرة؟ وما الدور الذي تؤديه في صياغة الوعي الجمعي وإنتاج المقاومة الرمزية والعملية؟
من المنظور الفلسفي، تطرح أربعينية الحسين جملة من الإشكاليات الوجودية والأنثروبولوجية, فما معنى إحياء الذاكرة؟ ما هو دور الشعائر في تشكيل الهوية الجمعية؟ كيف يمكن لموت فرد أن يتحول إلى مصدر دائم للمعنى؟ ما العلاقة بين الزمان والحق, الزمان والموقف؟ وهل ثمة فلسفة مخصوصة يمكن استخراجها من واقعة كربلاء وتجلّياتها الأربعينية؟
إن واقعة كربلاء لا تُفهم بوصفها حدثًا تاريخيًا فحسب، بل بوصفها "نصًا مفتوحًا" (بحسب تعبير بول ريكر) يتجاوز السياق الزمني الأول ليحمل إمكانات تأويلية مستمرة. أربعينية الحسين هي إعادة تنشيط لهذه الذاكرة من خلال شعائر حماعية تُجذّر الحدث في الضمير الجمعي، وتستعيده بوصفه نموذجًا يتجاوز الزمان والمكان.
في هذا السياق، يمكن الاستناد إلى مفهوم "الذاكرة الجماعية" الذي طوّره موريس هالبواكس، حيث يرى أن الذاكرة ليست فردية، بل تُنتج داخل الأطر الاجتماعية، وتُعاد صياغتها ضمن خطاب جماعي له وظيفة هوياتية. ومن هذا المنطلق، تشكّل الأربعينية لحظة زمنية لإعادة بناء الذاكرة الشيعية، ليس كحالة حنين إلى الماضي، بل كمقاومة رمزية للحاضر الظالم، وتمهيد لمستقبل بديل.
وقد ادت الهوية الاسلامية الشيعية دورا مهما في هذا السياق , اذ هي ليست مجرد انتماء طائفي، بل هي مشروع فلسفي يرتكز على مبدأ "الحق مقابل القوة"، وهو ما تجسّد في كربلاء وتُستعاد رمزيته في الأربعين. من هنا، فإن المشاركة في زيارة الأربعين أو إقامة مجالسها، ليست فعلًا تعبديا فقط، بل فعلًا سياسيًا – أنطولوجيًا يحمل رفضًا لكل أشكال الطغيان، ويؤكد على مركزية الإنسان الحر في مواجهة البُنى السلطوية . لذلك مازالت الانظمة الطاغوتية والمستبدة منذ إبان هذه الثورة تمارس ابشع انواع القهر والاضطهاد ضد من يحاول احياء تلك الذاكرة الجماعية , تلك الثورة التي حملت مسؤولية الرفض واسست له.
وفي ضوء فلسفة ميشيل فوكو حول الخطاب والمقاومة، يمكن النظر إلى الشعائر الأربعينية بوصفها "ممارسات خطابية" تعيد صياغة الذات في مواجهة أنظمة السيطرة. فالمشي إلى كربلاء، أو البكاء على الحسين، أو إقامة المجالس، ليست مجرد طقوس عاطفية، بل هي "جسدانية مقاومة"، حيث يصبح الجسد نفسه، من خلال المشي والتعب والآلام، وسيلة لإعلان الانتماء إلى مشروع الحسين الوجودي .
ان الإشكالية المركزية التي يجب بحثها هنا هي : كيف يمكن فهم أربعينية الإمام الحسين بوصفها ظاهرة فلسفية – وجودية، تتجاوز الطابع الشعائري لتصبح وسيلة لإنتاج المعنى، وبناء الهوية، ومواجهة الظلم؟ فما طبيعة العلاقة بين الشعيرة والهوية ؟ هل تمثل الأربعينية شكلًا من أشكال "الذاكرة المقاومة"؟ كيف يتقاطع الزمن الحسيني مع فلسفة التاريخ؟ هل يمكن اعتبار الحزن الحسيني فعلًا أخلاقيًا وليس مجرد عاطفة؟
ولكي نحاول الاجابة – ولو اجمالا – على هذه الاسالة الصعبة لابد لنا من الغوص قليلا فيما يذب اليه كبار الفلاسفة والعلماء ونعرض عليه بعضا مما ارادت كربلاء ان تقوله من حيث انها تمثل لحظة مفصلية في التاريخ الإسلامي، لكنها تتجاوز الحدث التاريخي لتُصبح "رمزًا" يعاد إنتاجه في المخيال الجمعي. في هذا السياق، يرى بول ريكور أن "الذاكرة ليست استدعاءً آليًا للماضي، بل فعلًا تأويليًا يعيد بناء المعنى , وبهذا تكون كربلاء متجددة المعنى على الدوام مع بقاء هيكلها الاساس كما هو.
أربعينية الحسين تمثل ذروة هذا الفعل التأويلي: لا يُستعاد فيها الحدث كما وقع، بل كما يُراد له أن يكون رمزًا دائمًا للثورة الأخلاقية. وفقًا لـ موريس هالبواكس، تُبنى الذاكرة داخل الأطر الاجتماعية، وهنا تلعب الأربعينية دورًا في تثبيت نموذج من الذاكرة الجمعية ذات الطابع المقاوم، مما يجعلها "ذاكرة مقاوِمة" في وجه النسيان السلطوي والتاريخ الرسمي.
لعل من اهم ما تمثله الشعائر الأربعينية، ولا سيما "المشي إلى كربلاء"، نموذجًا لفعل رمزي جسدي يتجاوز التعبد إلى التأثير الوجودي. يُظهر ميشيل فوكو كيف أن الجسد هو موقع السلطة والمقاومة معًا , وفي هذا الإطار، يتحول الجسد الحسيني إلى أداة مقاومة عبر الألم، والتعب، والمشي.
تُعيد الشعيرة تعريف الهوية لا بوصفها انتماءً جغرافيًا أو إثنيًا، بل بوصفها التزامًا وجوديًا بقضية عادلة, والماشي في طريق الأربعين لا يُعرّف عن نفسه بالانتماء الطائفي، بل بالانتماء إلى "مشروع الحسين"، وهو مشروع ينهض على مبادئ العدل، والكرامة، ورفض الظلم.
كما ان للزمان الكربلائي الميتا- تاريخي اهميته الكبيرة, اذ يميزالتراث اليوناني والفلسفة المسيحية بين الزمان الكرونولوجي الممتد وهو ما يطلق عليه ( الكمي ) والزمان الكايروسي وهو اللحظة النوعية الفارقة , أي انه لحظة خرج فيها الزمان عن رتابته ليصبح كثيفًا بالمعنى. الأربعينية تُعيد تكثيف هذه اللحظة، وتذكّر بأنها لم تكن حدثًا مضى، بل لا تزال قائمة في كل لحظة ظُلم.
وهذا يطرح سؤالًا فلسفيًا: كيف نعيش "الزمن"؟ هل هو خط مستقيم من الماضي إلى المستقبل، أم هو دائرة تعود فيها القيم إلى الواجهة كلما تجدد الاستبداد؟ الأربعينية تعلن أن كربلاء لا تنتهي، وأن التاريخ ليس تراكما حياديًا للاحداث ، بل ميدانًا للصراع بين القيم، وأن "الحسين" هو معيار الحقيقة في كل زمان, وفق هذا التصور، فإن كربلاء ليست حدثًا في كرونوس ( كميا , ماديا ) بل كايروس ( نوعيا , معنويا) لحظة زلزالية يتصدع فيها النظام الأخلاقي للواقع . كربلاء هي لحظة كايروسية بامتياز، أي لحظة خرج فيها الزمان عن رتابته ليصبح كثيفًا بالمعنى. الأربعينية تُعيد تكثيف هذه اللحظة، وتذكّر بأنها لم تكن حدثًا مضى، بل لا تزال قائمة في كل لحظة ظُلم , اربعينية الحسين تعيد هذا الكايروس الحسيني إلى الحاضر، فتصبح كل أربعينية "حاضرًا متجدّدًا للماضي"، وتُؤسس لفهم دائري للتاريخ، حيث لا تسير الأحداث خطيًا، بل تتكرر القيم حين يُعاد استحضارها بفعل الطقوس، مما يجعل من كربلاء حدثًا أبديًّا في التاريخ الأخلاقي, لتتحول من بُعدها التاريخي المادي الى بعدها الميتاتاريخي الارحب . من المثير فلسفيًا أن نلاحظ كيف تحوّلت أربعينية الحسين إلى ظاهرة كونية لا تقتصر على الشيعة أو المسلمين فحسب، بل يشارك فيها غير المسلمين أيضًا، تعبيرًا عن مشاعر إنسانية تتجاوز الانتماء الديني الضيق. وهذا يذكّرنا بفكرة "الرمز الكوني عند كارل يونغ، حيث تتكرّر بعض الرموز في لاوعي الإنسان الجمعي. الحسين، في وعي الكثير من المشاركين، لم يعد مجرد إمام أو شهيد، بل أصبح رمزًا للإنسان الكامل الذي واجه المصير، وأبى الانحناء. إن المسيرة نحو كرنلاء هي رحلة أنثروبولوجية نحو المعنى، نحو الذات الحقيقية، ونحو التلاقي مع الآخر في دروب البحث عن العدالة. وعندما كنت انادي الى رفع جميع رايات واعلام دول العالم في ساحة في كربلاء تتوسطها راية الحسين ( عليه السلام ) لم تكن دعوتي تلك عن ترف او سذاجة , وانما نابعة عن فهم عميق واصيل لروح كربلاء.
في كربلاء ينتقل الحزن من العاطفة الى الموقف الاخلاقي , فالبكاء في الأربعينية ليس تعبيرًا عن الضعف، بل هو "انخراط في جراحات الحقيقة"، ووسيلة لتوليد الوعي الأخلاقي – السياسي. كما أن التماهي الوجداني مع الحسين يُسهم في بناء ذات لا تقبل التعايش مع الظلم، ما يجعل من الحزن وسيلة للتحوّل الوجودي لا مجرّد شعور. اما في الفلسفات الكلاسيكية ينظرإلى الحزن كعاطفة يجب مقاومتها، لكنه في السياق الحسيني يُعاد تأطيره كحالة أخلاقية , وهنا يتبادر الى الذهن ما يذهب اليه ايمانويل ليفيناس حبث يرى أن "الوجه الآخر" يدعونا إلى المسؤولية الأخلاقية" وفي هذا الإطار، يصبح الحسين "الوجه المطلق للآخر المظلوم"، واستدعاء الحزن هو انخراط في هذه المسؤولية. من المألوف في الفلسفة الغربية أن الحزن يُنظر إليه كعاطفة سلبية يجب تجاوزها (كما عند الرواقيين أو حتى نيتشه)، لكن الحزن الكربلائي يمثل حالة فريدة من الحزن الخلّاق، القادر على إنتاج المعنى وتحفيز الفعل الأخلاقي. البكاء على الحسين، في هذا السياق، ليس ضعفًا، بل تعاطف وجودي مع مشروع الحق، واستبطان للظلم الذي ما يزال يتكرّر. أربعينية الحسين ليست مجرد تذكير بالحدث، بل استدعاء دائم للموقف الأخلاقي في أن لا نكون من الصامتين في حضرة الظلم، وأن نجعل من الحزن الفعّال دافعًا للإصلاح .
إن المشاركة العالمية في أربعينية الحسين، بما فيها من غير المسلمين، تؤكد على أن الحسين تجاوز حدود الدين ليصبح أركيتايبا ( نموذجا اوليا في اللاوعي ) الإنساني، على غرار ما يشير إليه (كارل يونغ) فالحسين ( عليه السلام )، بحسب هذا التصور، يمثّل البطل الأخلاقي الكوني الذي يواجه قوى الشر بلا مساومة. لذلك، فإن المسير إلى كربلاء ليس مجرد فعل ديني، بل هو "رحلة نحو الذات"، حيث يواجه الإنسان ضعفه، ويبحث عن كرامته، ويجد في الحسين مرآة لجوهره الأصيل.
إن أربعينية الحسين، بهذا المعنى، تشكّل فلسفة في الوجود، قاعدتها أن الإنسان لا يُقاس بالبقاء ( اي كم بقي حيا ) بل بالموقف، وأن الحياة ليست بما نملك، بل بما نضحي من أجله. الحسين عليه السلام، بهذا المعنى، هو فيلسوف الفعل، وواقعة الطف هي أولى مدارس الحرية في الفكر الإسلامي. إن هذه الأربعينية تفرض علينا إعادة النظر في الفلسفة نفسها، بوصفها ليست تأملاً في المفاهيم المجردة فقط، بل هي مشاركة في الحقيقة المُعاشة. كربلاء ليست مجرد موضوع للتفلسف، بل هي فعل فلسفي بذاتها ، لأن الحسين ( عليه السلام ) لم يُنظّر للحق بل جسّده، ولم يكتب في الحرية بل ضحّى من أجلها, لذا فان احياء معركة طربلاء ضرورة قصوى لروح الذاكرة الاسلامية التي طالما غذت الانسانية لانماط متجددة من الفكر والسلوك ضد الطغيان والاستبداد. من هذا المنظور، فإن إحياء الأربعينية ليس تكرارًا طقوسيًا، بل هو تأسيس دائم للمعنى، ورفض للصمت، ونداء للفعل الأخلاقي المستمر.
وفي الختام ارى ان من الواجب التاسيس لفلسفة كربلائية شاملة تقوم على اساس مشروع فلسفي متكامل الاركان يستمد كيانه من إعادة فهم الذاكرة بوصفها مقاومة للسلطة والنسيان , ومن بناء هوية اخلاقية منفتحة تتجاوز المذهب الى الانسان , ومن قراءة الزمن كحقل للقيم وليس فقط للاحداث , ومن تحويل الحزن من شعور الى موقف وجودي اخلاقي , ومن تفعيل الرموز الكبرى في انتاج المعنى وتحقيق الذات .
جاسم محمد علي المعموري
المراجع والهوامش
عبد الكريم سروش , النبوة والحقيقة
الشهيد مطهري , الملحمة الحسينية
الشهيد مطهري , الانسان والايمان
عبد الكريم سروش، النبوة والتجربة
عبد الجبار الرفاعي، الدين والظمأ الأنطولوجي
هالبواش، موريش. عن الذاكرة الجماعية. مطبعة جامعة شيكاغو. ريكور، بول. الذاكرة، التاريخ، النسيان. مطبعة جامعة شيكاغو. فوكو، ميشيل. التأديب والعقاب. كتب فينتاج. ليفيناس، إيمانويل. الكلية واللانهاية. مطبعة جامعة دوكوين. يونغ، كارل. الإنسان ورموزه. نشر ديل
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat













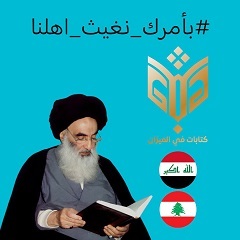
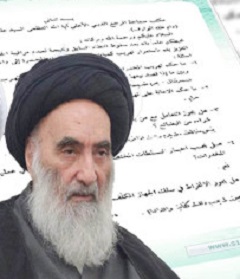

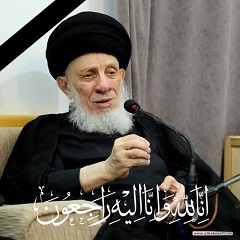

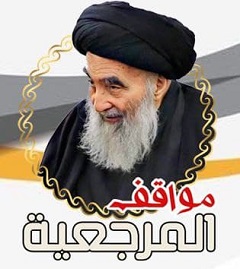

.jpg)